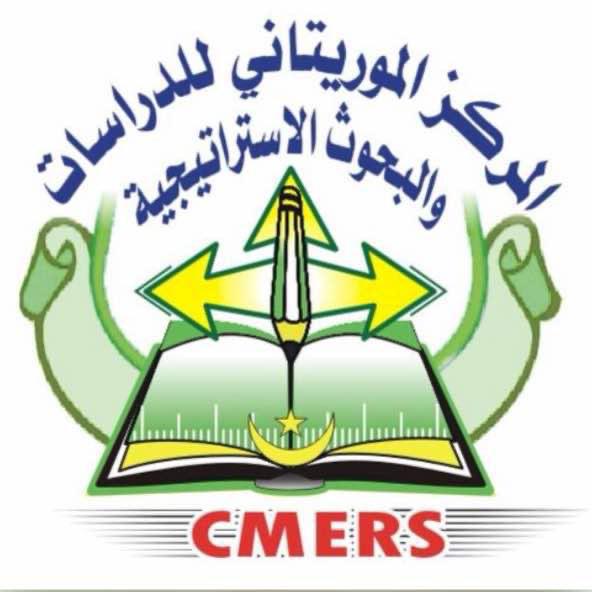آفاق التحول السياسي (خلال خمس سنوات قادمة)
نتائج الورشة التي نظمها المركز بمشاركة كل من: د. البكاي ولد عبد المالك والأستاذ محمد محمود ولد بكار والأستاذ محمد جميل ولد منصور والأستاذ محمد الأمين ولد الفاظل والأستاذ الحافظ ولد الغابد:
لئن كانت موريتانيا تجاوزت خلال العامين الماضيين، محطات سياسية كبيرة، كالاستفتاء الدستوري 2017 والانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية 2018فإنها مقبلة خلال خمسة أشهر على انتخابات رئاسية وسط ترقب سياسي لما ستسفر عنه هذه الانتخابات فيما يخص الانتقال الديمقراطي وزيادة تحسين الشروط السياسية لتنمية العملية الديمقراطية، في هذه الورقة سنحاول استشراف تحولات المشهد السياسي خلال السنوات الخمس القادمة.
وسنتناول الموضوع من خلال تشخيص الحالة السياسية، ثم التعرض لسيناريوهات التحولات المقبلة.
أولا: تشخيص للحالة السياسية:
رغم الاستقرار السياسي النسبي الذي يسود البلاد، فإن ثمة عوامل متعددة فاعلة تؤجج التوتر والاختلال وبالتالي استمرار عوامل الاضطراب المستمر والتثوير في الأرضية السياسية وبيئة النظام السياسي القائم، خصوصا أن ثمة تأجيلا مستمرا لعقود للإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تتيح لجهاز الدولة الاستجابة الفاعلة للمشكلات المطروحة على المستوى الإداري والاقتصادي والاجتماعي حتى يتم تفادي المخاطر الناتجة عن عوامل التوتر التي تغذيها حركية الحياة الاجتماعية، وما تولده التغييرات المتسارعة من مطالب موضوعية ملحة، تتعلق بالحاجات الأساسية للإنسان خصوصا في سياق يعرف تحولا متفاعلا مع طبيعة العصر الرقمي، وما تلقي به تقنيات التحرر من تأثير يسرع صناعة الحدث والتحول نفسيا واجتماعيا في زمن قياسي ويسير على نحو ما شاهدناه في واقع التحولات الجارية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وهنا لابد من التوقف مع المجالات التي كانت تتطلب إصلاحات ونقلات كبرى تقطع مع تأجيل استحقاقات الإصلاح والانتقال من الواقع المنحرف والمغذي للخطر الكامن، إلى ما يؤسس لتفاديه، وتأمين البيئة الحاضنة للمنتظم السياسي الوطني بكل أبعاده.
1. مخاطر الجمود وتأجيل الإصلاحات السياسية الكبرى:
عانت موريتانيا خلال العقود الماضية من جمود كبير، وضعف في أداء المنتظم السياسي، حيث سيطر العجز عن الاستجابة الإيجابية للتحديات المطروحة، وغدا تأجيل الإصلاحات الجوهرية الكبرى منهجا مسيطرا في سلوك الساسة أمام استفحال ظواهر باغتت الدولة الوليدة، كظاهرة الجفاف وما انجر عنه من تحول في نحل العيش وطرق الكسب بالنسبة لنسبة كبيرة من المجتمع البدوي الريفي، في حين لم تستطع الحكومات المتعاقبة تفادي الجمود الهيكلي وإحداث نقلات وبرامج تتمكن من علاج المشكلات المستحكمة، كما أن الإرادة السياسية ظلت عائقا أمام تطور الأداء العام لأجهزة الحكم والدولة وتمظهر ذلك بشكل بارز في النقاط التالية:
أ- انعدام الإرادة القادرة على ترسيخ وتطوير القواعد الحاكمة للديمقراطية والتعددية السياسية، فمنذ سنوات تعيش النخبة السياسية انقساما واسعا حول آليات وأساليب عمل المنتظم السياسي، بكل مكوناته (النظام/ المعارضة) ورغم أن آلية الحوار السياسي برزت ونشطت بشكل غير مسبوق في السنوات الخمسة عشر الماضية بدءً من الأيام التشاورية خلال المرحلة الانتقالية (2005/2007) وبعد الانقلاب على الرئيس المنتخب انطلق حوار داكار في يونيو2009 وهو المسار الذي تعزز بحوار آخر نظم في ما بين (17سبتمبر و19 أكتوبر2011) قاطعه طيف واسع من المعارضة، وما فتئت آلية الحوار مطروحة لكن دون الولوج للمتطلبات الكبرى، والمطالب المرغوبة للإصلاح، وخلال الأعوام 2014/2015 حصلت عدة محاولات لإطلاق حوار شامل إلا أنها جميعها فشلت وانطلق الحوار مجددا في الفترة ما (بين 20 سبتمبر وحتى 10 اكتوبر2016) وهو الحوار الذي قاطعته أبرز أحزاب المعارضة.
وفي آخر مرة انطلق حوار سري بين أحزاب المنتدى وائتلاف أحزاب الأغلبية ووصل لطريق مسدود فجر (14 ابريل 2018) مما قضى على أي أمل في تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات على أسس تضمن تمثيل المعارضة، وتُمكن من التوازن في موقف اللجنة الذي ظل تأثير السلطة عليها كبيرا، وانتقده حتى المشاركون في تأسيسها، مما أثر باستمرار على مصداقيتها.
والأسوأ أنه في هذه المحطات جميعها من الحوار والنقاش السياسي، لم تطرح القضايا الملحة، التي تخص بؤر التوتر ولم تتم ملامسة الجوانب الهامة للإصلاح السياسي:
فمن أهم الضمانات التي كان ينبغي التركيز عليها فيما يخص ترسيخ الديمقراطية، الفصل الجدي بين السلطات وتهذيب النظام الرئاسي السلطوي ذي الصلاحيات المطلقة الذي يحكم البلاد منذ السنوات الأولى للاستقلال، مرورا بفترات الحكم العسكري الاستثنائي، مما جعل الاستبداد والتسلط ثقافة إدارية ونمط حكامة في البلاد، وهو ما حدَّ من فرص التطور السياسي، والمؤسسي، مع دخول البلاد العهد الديمقراطي مطلع التسعينيات مع إقرار (دستور 20 يوليو 1991مـ)، ولذلك ولدت كافة المؤسسات في هذا العهد وهي مدجنة، وفاقدة للثقة في ذاتها لأنها لم تنبثق بصورة صحيحة، وإنما جاءت في سياق إصلاح جزئي تَكَيـُّفِيٍ للنظام العسكري مع التحولات الإقليمية والدولية، ولذلك فقد بقيت على الهامش.
وهذا ما يحتم إعادة صياغة البناء المؤسسي، حتى نكون أمام برلمان بصلاحيات قوية ووزير أول مسئول ومحاسب أمام البرلمان، وأغلبية ذات برامج تخضع للتقييم الدوري، والمحاسبة على الأداء.
وعلى مستوى القضاء إلغاء المجلس الأعلى للقضاء لأنه يكرس هيمنة الرئاسة على القضاء، ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات، كما أن إصلاح وتطوير المجلس الدستوري يبقى ضرورة لا غنى عنها بوصفه محكمة ذات صلاحيات مؤسسية ودستورية كبرى، مما يتطلب توفره على استقلالية تضمن أداء هذه المؤسسة لوظائفها بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذية والتبعية المطلقة لها، فضلا عن ضرورة إصلاح ومراجعة النظام الأساسي للقضاء، والنظر في إمكانية إضافة لبنة مجلس الدولة، لأنه لبنة يفتقر إليها النظام المؤسسي الموريتاني والذي يأخذ بالطريقة الفرنسية في هندسة المؤسسات السياسية، فوظيفة النظر في النزاعات الإدارية وضبط المعايير التنظيمية من النواقص القائمة في المؤسسات الموريتانية.
ولم تتطرق هذه المحطات بالجدية المطلوبة للوحدة الوطنية، ووضع ضمانات حقيقية للانسجام الاجتماعي، من خلال تكريس الحق في الاختلاف والاعتراف بالمكونات وثقافتها ولغاتها ووضع آليات لتعزيز ديناميات الانسجام والوحدة الوطنية.
ورغم جوهرية بلورة تصور لصياغة مخرج متفق عليه يضع حدا للتدخل السافر لأشخاص باسم الجيش في الحياة السياسية، ونتيجة لحساسية الموضوع، جاملت المعارضة السلطة فلم تطرح بشكل جدي، إشكالية العلاقات المدنية العسكرية، وتجاهلتها، وهو ما يحتم البحث عن مخرج ملتزم به يجنب البلاد آلية الانقلابات العسكرية كطريق وحيد لانتقال إدارة البلاد من رئيس للآخر، ومن المؤكد أن الدستور الحالي قد وضع أسسا جديدة لكن لا تتوفر لها الحماية الكلية من التلاعب وتسلسل الرئاسة في السلك العسكري فقط، دون أن تكون معايير الكفاءة ومصدر السلطة ذوي دور في تحديد راهن السياسية في الحال والمآل.
ب - فشل الأنظمة المتعاقبة في إرساء قواعد الحكم الرشيد في السياسة والاقتصاد وإصلاح الآليات الإدارية لتخدم التوجه الإصلاحي، وتفادي السير في نفس النسق الذي كرس الفساد بكل أشكاله سياسيا وإداريا واقتصاديا وحد من استفادة البلاد من كم كبير من الثروات التي تستخرج من البلاد، غير أن هذه الثروات لاتزال نهبا للشركات الأجنبية، ولم يستفد منها الاقتصاد العليل، الذي يعاني من مشكلات وأزمات مستمرة، تأجلت حلولها لعدة عقود، فتكرست ثنائية الفقر والفساد بشكل غير مسبوق.
ج- ولئن كانت عوامل الاضطراب قائمة منذ عقود، إلا أن المنتظم السياسي ظل عاجزا عن الشروع الجدي في سياسات وبرامج مواجهة عوامل الاضطراب، التي تهدد كيان الدولة وبقاءها المستقبلي، فـالتفاوت الاجتماعي، وانتشار الفقر والأمية واتساع الهوة بين الفقراء والأثرياء ظل هو السمة الغالبة، وتكرس في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق.
2. توترات الوحدة الوطنية:
منذ أحداث 1966مـ واختلالات الوحدة الوطنية من أبرز التحديات التي رَحَّلَتْهَا كل الأنظمة للمستقبل، وأجلت الحلول بشأنها، وهو الخطأ الاستراتيجي الذي أنتج باستمرار هزات ومشكلات وأزمات عمقت هذا الإشكال، كما حصل في سنوات (1987مـ و89 و90/91) وما تلا ذلك من أخطاء عمقت هذا المشكل على مستوى مكونة الزنوج، ولا يزال مشكل تلك الأحداث عائقا مستمرا يثقل ذاكرة المصالحة الوطنية، التي تمت فيها تسويات جزئية، تجاهلت تصفيات العسكريين 1990 في إينال وولاتة والعزلات وسُورِي مالاّ، حيث تمت خياطة جروح هذه القضايا على قيح وصديد مُنذِرٍ بغَضَبَاتٍ وتوترات تُغَذِّي عوامل التوتر، وتساهم فيها.
أما إشكال الرق والطبقية ومخلفاتهما، فلم تحظ باهتمام كبير، ولا تزال تواجه تأجيلا مستمرا، خصوصا على مستوى الحلول الناجعة، القادرة على احداث مُتغَيِّراتٍ ونُـقلاتٍ كبيرة، تتفادى تحول المطالب الاحتجاجية المتصاعدة إلى مشاكل مستحكمة، تشتعل تحت الرماد، منذرة في أي لحظة بحالة انفجارات بركانية قادمة.
3. استدامة الاستقرار وبناء الثقة:
إن استدامة الاستقرار والاستجابة الفاعلة لتحديات التنمية تتطلب تحقيق ثماني شروط لابد من توفرها:
- تأسيس الحكامة السياسية على أساس الشرعية السياسية الكاملة المبنية على الثقة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
- تحقيق الانسجام والتماسك الاجتماعي بناء على العدالة الراسخة والتوزيع العادل للثروة.
- ضمان سلامة المنظومة السياسية وتفادي العوامل السلبية التي يمكن أن تنحرف بالنظام والمؤسسات عن أهدافها الكلية المرسومة.
- خلق فرص للنجاح في كافة التحديات والعوائق المطروحة وعدم الاستسلام للفشل.
- إصلاح نُظم التعليم، وتفادي تكرار ما حصل في الماضي من خلال تأسيس ثقافة جديدة تحقق قطيعة مع ماضي التراجع ونفسية الفشل والانهزام التي كانت مسيطرة.
- إقرار مبدأ التميز الإيجابي لصالح الطبقات المهمشة والاستفادة من مناهج العدالة الانتقالية في تأسيس نهضة وطنية منسجمة وشاملة.
- تطوير الحكامة الاقتصادية والاستجابة لمتطلبات الجيل الحالي دون إضرار بالأجيال المستقبلية من خلال التنمية المستدامة الدارجة على أسس سليمة تحقق الاستقلال الوطني والشراكة على أسس عادلة مع الغير، وتسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية المتوازنة والشاملة.
- احترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون على الجميع دون استثناء وتفادي المحسوبية والفساد.
وكما تشير العديد من الدراسات التي كتبت عن تكنلوجبا التحرر، فإن ثمة فرصا كبيرة للتحول والتحرر، ولكن توجد أيضا مخاطر قد تَحرِفُ إرادة التحرر، وتسرقها للوقيعة بالتحولات لدركات أسوء من الأوضاع التي كان يراد التحرر منها، ومن أهم العوامل المؤثرة في هذا السياق:
- أن انتشار وشيوع استخدام تكنلوجيا المعلومات أو تقنيات التحرر من الفساد، يتعزز ويتسارع وحتما سيؤدي لتغييرات كبيرة.
- عجز العديد من الأنظمة في الدول الضعيفة عن التحكم في صيرورة تطورات الأحداث، مما يعزز فرضية حصول تغييرات كبيرة مفاجئة خلال السنوات القادمة.
- أن الشركاء الخارجيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بإزاء ما هو جار من تحولات، وتدخلاتهم لن ترتكز إلا على ما يعزز مصالحهم.
- أن النخب السياسية بحاجة لتطوير مسار العلاقات المدنية العسكرية، لما يتعزز من دور مستقبلي للأبعاد غير العسكرية لأمن الدولة القومي والاستراتيجي، لأنه بات جزءً وظيفيا، ومندرجا في أدوار منظومات دولية وأولويات إقليمية أقوى.
وانطلاقا من معالم التشخيص السابق، فإن أي تفكير مستقبلي لا يتضمن المقترحات الجدية في اصلاح أسس الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يشكل مساهمة في التجديف الذي ارتكبته الأنظمة والحكومات السابقة دون الوصول لحلول جوهرية للملفات الأكثر خطرا على مستقبل الكيان الموريتاني المهدد بالغرق في مشكلاته وأزماته في أي وقت، ولا منجى له من شراك ترحيل أزماته المستمر، إلا وقفة مع الذات، جازمة تبتغي التوصل لحول ناجعة وسريعة.
ثانيا: سيناريوهات التحولات المقبلة
يبقى استشراف التحولات السياسية في هذه اللحظة من الصعوبة بمكان، وذلك راجع بالأساس إلى غموض الرؤية، واختلال ميزان القوة لصالح النظام بشكل كبير، فلم تستطع القوى السياسية التأسيس للتحول السياسي، وتفادي استمرار الأزمات ذاتها، التي كانت قائمة منذ عقود.
ويبقى إحداث تحول سياسي جزئي هو أفضل الخيارات السياسية المتاحة، كما أنه هو المتسق مع طبيعة التغيير والصيرورة الرتيبة في البلاد، كما أن ثمة مخاطر تحيق بالبلاد بين يدي تحول 2019، فإما أن تبدأ البلاد خطوة الألف ميل، من خلال تحقيق انتقال السلطة بالانتخاب، أو حصول تراجع، بالتلاعب بالدستور، والعودة من جديد لمربع الانقلابات كآلية وحيدة للانتقال. ويظهر حتى الآن أن هذا الخيار الأخير بات مستبعدا، بعد إعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن مرشحه للانتخابات القادمة هو وزير الدفاع الحالي الفريق محمد ولد الغزواني، وتأكيد هذا الأخير لصحيفة جون آفريك نيته الترشح في الانتخابات القادمة.
إن معالم المشهد الراهن في سياق تحولاته المرتبطة بالأدوات الديمقراطية، يتسم وبوجود وضع اجتماعي متأزم، يصادف نهاية مأمورية رئاسية، يمنع الدستور شخص الرئيس الحالي من الترشح لولاية ثالثة.
كما أن ثمة معارضة متحفزة، ولكنها قد تضيع فرصة التأسيس من خلال التحول لما هو أعمق عبر آلية ممهدات، وإصلاح سياسي متدرج.
يوجد وضع اقتصادي، صعب ولكن تلوح في الأفق القريب فرصة تغييرات كبيرة، على نحو ما هو منتظر من بدأ دخول عائدات الغاز للسوق خلال السنوات (2021/2022) وما سيتيحه هذا المورد من فرص ستدخل متغيرات اقتصادية وسياسية مؤثرة.
ومن الأخطاء التي قد ترتكبها السلطة / أو الأغلبية الداعمة لها إذا ظنت أن النظام المقبل ينبغي أن يكون أمتدادا للنظام السابق وأن تستمر الأمور في ظله على ما هي عليه، دون أن تكون هناك إصلاحات ولو جزئية، كما أن المعارضة هي الأخرى قد تقع في خطأ كبير إن ظنت أن ثمة فرصة للتغيير الكلي، أو توقعت أنها يمكن أن تهزم النظام ببنيته الحالية، والذي يمتلك تقريبا الجزء الصلب من معادلة ميزان القوة، ببعديه السياسي والاجتماعي، ولا ينتظر على الأقل بين يدي 2019 حصول تغييرات كبيرة على هذه البنية.
ويمكن أن نتصور النظام القائم الآن مرتكزا على واجهتين:
- واجهة سياسية تمثلها الدولة الديمقراطية المدنية وهي واجهة صورية غير حقيقية.
- واجهة اجتماعية تتكون من كشكول ما يُعبر عنه أحيانا بالدولة العميقة، المرتكزة على القبيلة والجهة، والطبقة مستغلة القوة العسكرية، في ظل هذه الظروف فإن المعارضة لا يمكن أن تصل إلى السلطة إلا عبر اختراق كبير للدولة العميقة، وضمان تأييد الكتلة الحرجة فيها القادرة على ترجيح الكفة لصالحها.
وثمة في هذا السياق ثلاث سيناريوهات فيما يخص تحول 2019:
-السيناريو الأول: أن تنتقل السلطة للمعارضة في السياق الحالي، وهو خيار غير مستحسن؛ نتيجة ضعف خبرة المعارضة بالعديد من الملفات، وخصوصا الأمن القومي في أبعاده الإقليمية والدولية، وكذلك حساسيتها المفرطة تجاه الوضع الداخلي، وتجاه المؤسسة العسكرية، وكذا مخاطر فتح ملفات أخطاء الحكامة السياسية للنظام المغادر وما سيترتب على ذلك من أزمات.
- السيناريو الثاني: أن يظن معسكر السلطة والموالاة وداعميها أن الأمور يمكن أن تستمر على حالها، وهذا هو الخيار الأسوأ، إذ إنه مدخل من مداخل التغيير العنيف، خصوصا وأن هناك تيارا في السلطة يرى أن مصالحه مرتبطة باستمرار الوضع، ولذلك يضغطُ هذا التيار من أجل استمرار الرئيس الحالي مؤثرا في السلطة ومتحكما في مفاصلها الرئيسية، متجاهلا الكثير من المُتغيرات الفاعلة والمخاطر.
- السيناريو الثالث: أن يحدث تحول من داخل النظام، يقوم بوظيفة التصحيح، يبدأ هذا التحول تدريجيا بإصلاحات هيكلية، إلى أن يصل في منحناه النهائي لما يشبه الثورة الهادئة، وهذا السيناريو هو الأفضل، لكونه يُمثل أهم ضامن للمحافظة على مستوى المكتسبات الحاصل، مع تجديد لمنظومة الحكامة، وتحقيق الأولويات الضرورية، فيما يخص التوزيع العادل للثروة، والاستقرار ومراكمة التنمية بشكل أفضل، ويُحقق مكاسب ويتفادى المخاطر، كما أن هذا التحول ممكن ولا يكلف ثمنا باهظا لجيمع الأطراف.
ويقترح أصحاب هذا السيناريو أن يتم في ثنايا هذا التحول، أو الثورة الإصلاحية الهادئة، اتفاقا بين النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع الدني، يتضمن جملة أمور:
- منع المساءلة القانونية لجميع الحكومات التي حكمت في ماضي البلاد.
- تحديد عقوبات رادعة ابتداء من توقيع الاتفاق لمن يرتكب فسادا خصوصا فيما يتعلق بالمال العام.
- انتخاب نائب للرئيس.
- إعادة تحديد المهام العسكرية ودور الجيش في الدولة.
- إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات على أسس تضمن النزاهة والتوازن والشفافية في تسيير العمليات الانتخابية.
- التزام الطرف الفائز في الانتخابات باتباع سياسة اجتماعية فيما يخص ملفات الصحة والتعليم وتخصيص ثلث الموازنة للتعليم.
في حال فشل الخيار الثالث:
- إذا لم تساعد المعارضة في خلق الظروف المناسبة للانتقال فإنها تتحمل المسئولية في تعطيل وعرقلة تطور المسار السياسي.
- إذا لم تساعد الأغلبية في العبور الآمن فستخسر السباق وتعرض البلد لعدم الاستقرار وتتحمل تبعات ذلك.
ومما يُميز المرحلة السياسية الراهنة، أن الرئيس لأول مرة، وبموجب القانون يكون راغبا وجزء واسع من حاشيته في البقاء ولكنه غير قادر على البقاء، وهو يحاول التحكم في العملية، والآليات لذلك لا تخلو من مخاطر.
وتبقى وضعية المؤسسة العسكرية تحديدا بحاجة لمقاربة فيها مستوى من الجدة، قد يكون من معالمها التفكير في مرحلة انتقالية يحصل فيها التحول وتتم فيها طمأنة الجيش، وكسب ثقته لصالح تطوير الحكامة السياسية، وتلافي مخاطر الانفجارات الاجتماعية، وتداعياتها المدمرة للبلاد.